ملخص المقال
تنوع الكتابة في السيرة النبوية مقال لوائل عزت معوض يعرض فيه لأهم المؤلفات التي خصها العلماء لبعض جوانب السيرة النبوية ككتب الشمائل ودلائل النبوة
تنوعت الثقافة الإسلامية خاصة بعد القرن الثاني الهجري، واتسعت رقعة الخلافة الإسلامية، واكتملت أدوات البحث، ودُوِّنت عيون المسائل والأبواب؛ فكان من الطبيعي ظهور المدرسة الموسوعية التي نوعت في الكتابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد خص العلماء بعض جوانب سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- بمزيد اختصاص، فأفردوها بالتأليف والعناية، ومن هذه الكتب المتخصصة:
أولاً: كتب الشمائل
وهي الآداب والأخلاق التي تمتع بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختص هذا اللون من كتب السيرة النبوية ببيان الصفات الخِلقية والخُلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، وعاداته وآدابه، وسلوكه وفضائله، كما تهتم كتب الشمائل النبوية بذكر الجوانب النادرة في سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذه الجوانب من الصعوبة أن نجدها في كتب السير أو المغازي، أو أوعية كتب السنة على ضخامتها، حيث نجد هذه الجوانب مفرقة ومبثوثة في أبواب كثيرة ومتنوعة من كتب الحديث والسنة؛ مثل: كتاب الأدب، وكتاب الاستئذان، وكتاب اللباس في صحيح البخاري، وكتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب الزهد والرقائق في سنن الترمذي، فأفرد أهل الحديث مصنفات كاملة عن شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
وتعطينا كتب الشمائل صورة تقريبية لهيئة الرسول وصفاته الخلقية والخلقية، وتجعلنا نرى كيف كان يعيش النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعاملاته وسياسته.
وأقدم مَنْ ألَّف فيها هو: أبو البختري وهب بن وهب الأسدي (ت: 200هـ) في كتابه صفة النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم الحافظ أبي الحسن علي بن محمد المدائني (ت: 270هـ) في كتابه: (صفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم).
وأشهر هؤلاء هو الإمام الترمذي (ت: 279هـ) في كتابه الشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية، وحققه الأستاذ الدعاس، ثم اختصره وحققه الشيخ ناصر الدين الألباني. وهو أشهر هذه الطائفة من الكتب، وجمع الترمذي 397 حديثًا في شمائل النبي -صلى الله عليه وسلم- وقسمها على 56 بابًا.
ولقد لاقى هذا الكتاب اهتمامًا كبيرًا من العلماء على مر الأيام واختلاف السنين؛ فمنهم من قام بشرحه، ومنهم من قام بتلخيصه؛ وفي العصر الحديث لاقى اهتمامًا كبيرًا من جانب المحققين حيث انكب على تحقيقه أكثر من محقق؛ (كالأستاذ عزت عبيد الدعاس، ومحمد عبد العزيز الخالدي، ومحمد عوامة، وأبي الفوارس أحمد فريد المزيدي)، وقد توالت طبعات هذا الكتاب وتسابقت دور النشر في نشره وتوزيعه.
ومن الذين ساهموا في شرحه: الملا علي بن سلطان محمد القاري الحنفي (ت: 1014هـ) في كتابه جمع الوسائل في شرح الشمائل، وهو شرح مطول أكثر فيه شارحه من عرض المسائل الفقهية.
والإمام الفقيه إبراهيم بن محمد الباجوري الشافعي (1198-1277هـ) في كتابه المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية.
ومن الكتب الشهيرة -أيضًا- في هذا الباب:
• كتاب: أخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم- وآدابه للحافظ أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ (274-369هـ= 887-979م)، ولقد ضم الكتاب بعض الأحاديث النادرة التي لا توجد في مرجع آخر من كتب السنة أو السيرة.
• وكتاب: مشكاة الأنوار في فضائل النبي المختار وشمائله، لمحيي السنة الإمام الحسين بن مسعود البغوي (432-516هـ = 1045-1117م)، وقد احتوى هذا الكتاب على 1257 حديثًا نبويًّا.
• وكتاب: الشفا في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (476-544هـ = 1083-1149م). وهو ليس كتاب سيرة بالمعنى الدقيق؛ ولكنه اشتمل على كثير مما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيامه برد بعض الأباطيل التي ألصقت بالسيرة.
• وكتاب: الوفا بأحوال المصطفى للعلامة الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي (508-597هـ = 1114-1201م)، والكتاب يعد أنموذجًا من نماذج تطور التأليف في كتب السيرة النبوية، وهو يعد موسوعة في السيرة النبوية والشمائل المحمدية.
• وكتاب: زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم الجوزي (691-751هـ = 1292-1350م)، ويرى بعض الباحثين أنه أول كتاب ألف في فقه السيرة[1]، وهو بحق يعدُّ موسوعة جمعت بين علوم شتى من السيرة والفقه والتوحيد واللطائف في التفسير والحديث والفقه.
• كتاب: شمائل الرسول للحافظ ابن كثير (701-774هـ = 1302-1373م) وهو مطبوع الآن بتحقيق طه عبد الرءوف سعد، وهو جزء من تاريخ البداية والنهاية.
وقد جمعت هذه الطائفة من الكتب بين الصحيح والضعيف؛ ولكن المحققين بذلوا عناية فائقة لتخليصها من غير المقبول منها.
ثانيًا: كتب دلائل النبوة، أو أعلام النبوة
اهتم هذا النوع من المؤلفات بذكر الإرهاصات والمبشرات بنبوة النبي -صلى الله عليه وسلم- والدلائل عليها، واتجه كُتاب الدلائل إلى إثبات ما يمكن إثباته من المعجزات، ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهم المواضيع أنه -صلى الله عليه وسلم- خاتم النبيين، والكلام عن معجزاته الباهرة، ودفع شكوك المتشككين بقوة الحجة والمنطق، وتمثل كتب الدلائل رافدًا مهمًّا من روافد علم السيرة النبوية.
ويعد أقدم من أفرد الدلائل بالتصنيف هو الإمام الحافظ أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي (207-301هـ = 822-913م) في كتابه: دلائل النبوة.
وأشهر من ألف في هذا النوع هو الحافظ أبي نعيم الأصبهاني (336-430هـ = 948-1038م) وذلك في كتابه: دلائل النبوة، والإمام أبو بكر البيهقي (384-458هـ = 994-1066م)، وذلك في كتابه: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. ولا يقتصر كتاب البيهقي على الدلائل فقط؛ بل اشتمل على المبعث والمغازي، واستوعب كل مراحل السيرة. وقد طبع في 7 مجلدات، بتحقيق د. عبد المعطي قلعة جي.
وأعلام النبوة، للحافظ شيخ الإسلام أبي حاتم الرازي (195-277هـ = 810-890م).
وأعلام النبوة، لأبي القاسم البغوي (214-317هـ = 830-929م).
وأعلام النبوة، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (364-450هـ = 974-1058م).
وعلامات النبوة، لأحمد بن أبي بكر البوصيري (762-840هـ = 1360-1436م).
ثالثًا: كتب الخصائص النبوية
وهي طائفة من الكتب تهتم بما امتاز به -صلى الله عليه وسلم- عن بقية الخلق من خصائص اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نوع جديد عُرف بالخصائص النبوية، وظهر هذا اللون كامتداد طبيعي لكتب الشمائل النبوية، ولقد اقتصر هذا اللون من السيرة النبوية على ذكر الخصائص التي أعطاها الله لنبيه -صلى الله عليه وسلم- وما اختصه بها دونًا عن سائر الأنبياء والبشر.
وأشهر مَنْ ألف في هذا الفن هو جلال الدين السيوطي (849-911هـ = 1445-1505م)، الذي جمع طائفة كبيرة من شمائل النبي -صلى الله عليه وسلم- وضمها كتابه المعروف بـ(كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب، والمشهور باسم: الخصائص الكبرى)، وقد جمع السيوطي طائفة كبيرة من الدلائل والشمائل من السيرة النبوية.
وللسيوطي كتاب آخر في (المعجزات النبوية) و(الشمائل الشريفة، والذي جمع فيه السيوطي 721 حديث).
رابعًا: المدرسة الأدبية أو مدرسة (البيان العربي)
- مدرسة الشعر الأدبي
صَوَّر الشعراء الكثير من مشاهد السيرة النبوية وأحداثها تصويرًا حيًّا من قلب الأحداث، كما نرى ذلك في قصائد حسان بن ثابت، وقد احتوت كتب السير والمغازي على عدد كبير جدًّا من قصائد الشعر التي قيلت على ألسنة الشعراء في ذلك الوقت، أو ما قيل منها على ألسنة الصحابة كـ كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة.
"ينبغي الانتباه إلى أن كتب الأدب تُعنى بالشاذ والغريب، والطريف فتدونه أكثر من عنايتها بأحداث الحياة الرتيبة، ومن هنا نتبين خطورة تعميم ما فيها"[2].
1- المدائح النبوية
لقد تحول فن الرثاء الشهير في الجاهلية إلى فن المدائح عندما تناول الشعراء شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت العرب قبل ذلك تسمي ما يقال في الإنسان بعد موته رثاء، ومن أشهر قصائد هذا الفن ما أذيع على لسان الخنساء وهي ترثي أخاها صخر. ولقد اتفق الشعراء والأدباء على أن ما يقولونه في حق النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد موته هو من قبيل المدح، وكان ذلك مظهرًا من مظاهر الاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نظم الشعراء قصائد في مدح رسول الله أثناء حياته؛ مثل قصائد حسان بن ثابت وكعب بن زهير.
ومن أشهر أعلام تلك المدرسة: حسان بن ثابت، وكعب بن زهير، ولسان الدين ابن الخطيب، والبوصيري الذي خص النبي -صلى الله عليه وسلم- بنحو عشر قصائد مطولات أشهرها البردة والهمزية.
يقول في أحد مدائحه:
أرى كل مدح في النبي مقصرا *** وإن بالغ المثني عليه وأكثرا
إذا الله أثنى بالذي هو أهله *** عليه فما مقدار ما تمدح الورى
وقد جمع الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني (ت: 1350هـ) الكثير مما قيل في مدح النبي -صلى الله عليه وسلم- في المجموعة النبهانية في المدائح النبوية، وجمع الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي الكثير من ألوان الشعر في كتابه: محمد -صلى الله عليه وسلم- على ألسنة الشعراء، وقد خص الدكتور حسين مجيب المصري (غزوات الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين شعراء الشعوب الإسلامية) وهي دراسة في الأدب الإسلامي قارن فيها بين الغزوات في الشعر العربي والشعر التركي والشعر الأوردي.
ويأتي على رأس هذه المدرسة في العصر الحديث أحمد شوقي في معارضته لقصيدة البوصيري.
ومن الغريب العجيب أن يمدحه بعض الشعراء النصارى في العصر الحديث أمثال: مارون عبود، وجبران خليل جبران، وإلياس فرحات، الذي يقول في قصيدته المطولة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
غمر الأرض بأنوار النبوة *** كوكبٌ لم تدرك الشمس علوه
لم يكد يلمع حتى أصبحت *** ترقب الدنيا ومن فيها دنوه
يا رسول الله إنا أمةٌ *** زجها التضليل في أعمق هوةْ
قل لأتباعك صلوا وادرسوا *** إنما الدين هدى والعلم قوةْ
2- المولد النبوي
يرجع هذا اللون من ألوان الكتابة في السيرة النبوية إلى القرن السادس الهجري، وقد اعتنى هذا اللون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الكتب تكتب للاحتفاء بذكرى المولد كل عام، ويتم تناول ما صاحب ميلاده -صلى الله عليه وسلم- من إرهاصات وآيات، وما صاحب هذه النشأة من خوارق العادات، ثم الحديث عن بعثته صلى الله عليه وسلم، وما تحمَّله -صلى الله عليه وسلم- من إيذاء في سبيل تبليغ الرسالة، وما منَّ الله به عليه من المعجزات والخصائص بعد النبوة.
ومن أشهر كتب المولد ما كتبه كمال الدين بن الزملكاني (ت: 627هـ)، وهو شيخ الإمام ابن كثير، وله كتاب في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إليه ابن كثير، وذكر أنه تضمن شيئًا في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عقد فصلاً في هذا الباب، فأورد فيه أشياء حسنة، ونبَّه على فوائد جمة، وفوائد مهمة وترك أشياء أُخر حسنة.
وللحافظ ابن دحية عمر بن الحسن الكلبي الأندلسي (544-633هـ = 1150-1236م) كتاب نهاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقع في جزأين في مجلد واحد، وقد شاع عنه أنه أول من ألف المولد حين صنف كتاب: التنوير في مولد السراج المنير، والثابت أن ابن دحية ألفه سنة 604هـ[3]، فقد تقدمه تآليف كثيرة.
وللحافظ عبد الرحيم العراقي (725-806هـ = 1325-1404م) كتاب: المورد الهني في المولد السني، ومن المؤلفين الشاميين: قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور الحلبي (664-735هـ = 1266-1335م) وله: المورد العذب الهني في الكلام على سيرة عبد الغني[4].
لقد كانت أغلب الكتابات المتأخرة في هذا الفن للصوفيين، وجاءت في أغلبها مبتذلة ومنحرفة عن المفاهيم الصوفية السنية، وقد خضعت كتابتهم للسجع المفرط.
ويجمع هذا اللون من الكتب الصحيح والضعيف من دون تمحيص، وفيها من الأحاديث التي يعجز أهل هذا الفن عن معرفتها، فمعظمها أحاديث لا يجوز الاحتجاج بشيء منها.
- مدرسة النثر الأدبي
لقد كان دخول الجاحظ (150-255هـ= 767-869م) مضمار السباق في التأليف في مجال السيرة النبوية دخولاً مثيرًا، وربما يكون خروجًا عن المألوف وشذوذًا عن المنهج المتبع في ذلك الوقت.
وللجاحظ كلام وحديث طويل عن بلاغة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ذكره في الجزء الثاني من كتابه البديع: البيان والتبيين، وفيه يتحدث الجاحظ عن "خصائص البيان النبوي وطريقة الجدل المحمدي وسمات الألفاظ والجمل في الحديث الشريف وطيب موقعها في النفوس، ثم يشفع ذلك بأمثلة من الأدب المحمدي كان أول من اختارها -فيما أعتقد- من الأدباء"[5].
ثم تابع الشريف الرضي (359-406هـ= 970-1015م) ما قام به الجاحظ، ويعتبر الشريف الرضي هو أول من أفرد كتابًا خاصًّا وقفه بالكامل على تتبع ألوان المجاز في كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسماه: المجازات النبوية، جمع فيه ما يقارب 360 حديثًا نبويًّا ليشرح ما فيها من ألوان المجاز.
خامسًا: المدرسة الموسوعية
ثم نشأت مدرسة علمية، حاولت تدوين كتب موسوعية شاملة في السيرة النبوية، ومحاولة جمع كل ما تيسر جمعه من كتب السيرة في هذه الموسوعات الضخمة بعد تنظيم المعلومات وترتيبها، ومن أشهر هؤلاء العلماء على سبيل المثال:
• تقي الدين أحمد بن علي المقريزي (766-845هـ= 1365-1441م) صاحب كتاب: إمتاع الأسماع بما للرسول -صلى الله عليه وسلم- من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع، وهو عمل موسوعي ضخم ضمن جوانب كثيرة وعديدة من حياة الرسول وسيرته النبوية، وهو تلخيص جيد لجميع أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولكنه تلخيص رجل عارف بحدود موضوعه، وإن لم يسلم فيه من المآخذ.
• محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت: 942هـ=1536م) صاحب كتاب: السيرة الشامية المسماة: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، وهو بحق موسوعة في السيرة النبوية، وقد فاقت مصادر معلوماته التي اعتمد عليها الـ 300 مصدر.
ويؤخذ على الكتاب الاستطرادات، كما يوجد به الكثير مِن الأخبار والروايات الملصقة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ليست مِن سيرته، ولقد عَقَدَ المؤلف -رحمه الله تعالى- في هذا الكتاب أَلفَ باب، وأورد الكثير من الروايات من دون تمحيص أو تثُّبت، فجمع الغث والسمين، وتغافل عن أنّ هذا الروايات في السيرة، قد كانت نوعًا مِن التوثيق الذي لا بُدَّ منه في مرحلةٍ مِن مراحل النقد والتمحيص لروايات السيرة.
المصدر: الألوكة.
[1] فاروق حمادة: مصادر السيرة النبوية وتقويمها، الدار البيضاء، دار الثقافة، ط1، 1401هـ، ص108.
[2] د. أكرم العمري، السيرة النبوية الصحيحة، ط1، ص71.
[3] المقَّري: نفح الطيب 2/104.
[4] عبد الغني: هو الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي (ت: 600هـ)، انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء، 21/443، 448.
[5] محمد رجب البيومي: البيان النبوي، دار الوفاء، ص310.






![نصيحتي لك: اذكر الله [1 / 12] نصيحتي لك: اذكر الله [1 / 12]](https://www.islamstory.com/images/upload/content_thumbs/1913613138ragheb-al-serjany-videos.jpg)
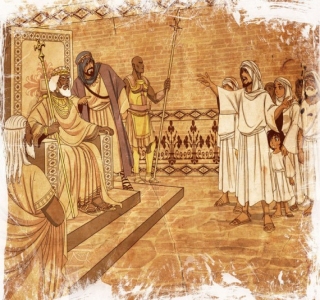

التعليقات
إرسال تعليقك